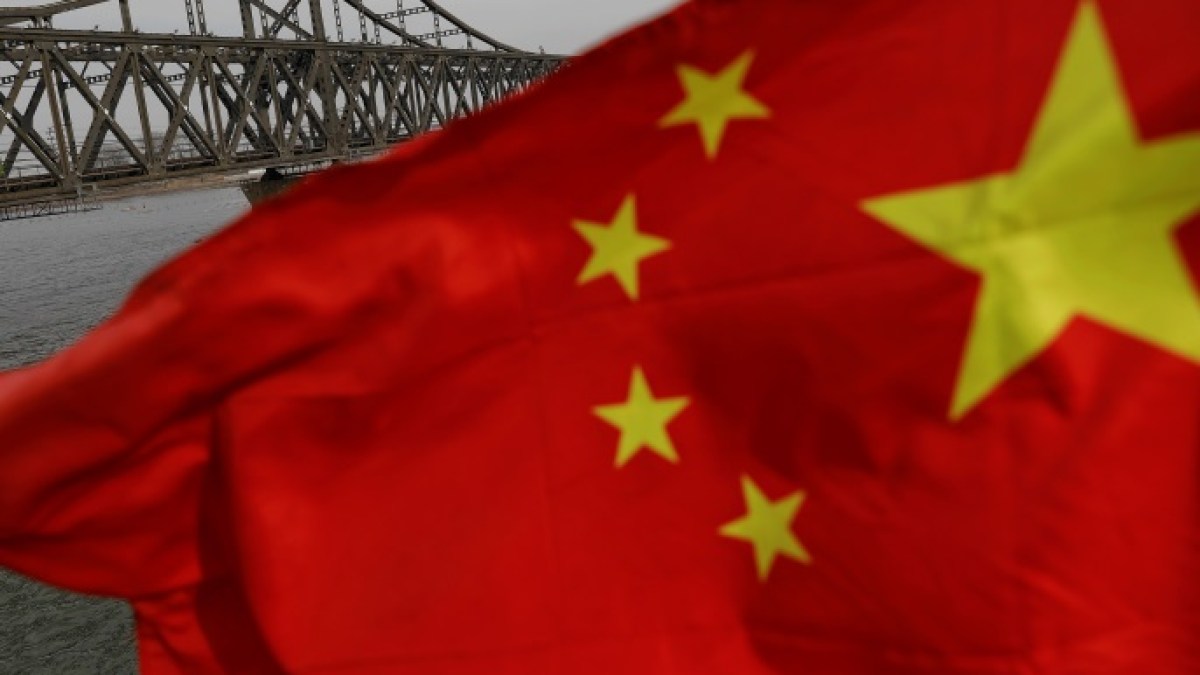منذ كتب إيميل حبيبي قصته القصيرة “بوابة ماندلباوم” سنة 1959 نشأ أدب ما يمكن أن نسميه “أدب الحواجز”، فكتب زياد خداش قصته “كاتب قصة قصيرة لا ينفذ أوامر الجنود” وجعل أحداثها عند “حاجز عطارة”، وكتب عزمي بشارة رواية “الحاجز.. شظايا رواية”، وكتب علاء حليحل “قصة باسبورت 2011” وكتب يسري الغول غزة 87، ليتحول الحاجز إلى كيان حي في حيوات الفلسطينيين، وصار فضاء مركزيا ومصيريا يضع الفلسطيني كل يوم موضع خطر ليتوقف الفضاء على أن يكون نقطة عبور عادية إلى نقطة استنزاف روحي وجسدي يقضي عنده الفلسطيني الساعات الطوال كل يوم ذهابا وإيابا وهو يلاحق حقه في الحياة والعمل والتنقل.
في هذا الفضاء الجحيمي الذي يتكاثر كل يوم منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تضع باسمة التكروري أحداث روايتها “عبور شائك” الصادرة عن دار مرفأ في طبعتها الثانية.
كابوس الحاجز
في حاجز قلنديا الفاصل بين القدس المحتلة ورام الله تنزل باسمة التكروري الأحداث الرئيسية لروايتها وكما تشي به كلمة “شائك” في العنوان من صعوبة تكون الكاتبة قد قبضت حبكتها. وكان الكاتب الكردي السوري سليم بركات يعرّف الرواية باعتبارها اختراع المأزق.
عند هذا الفضاء المعادي تستضيف الكاتبة تخييليا 3 من الشخصيات الفلسطينية منار وزياد وشذى لكل شخصية حكايتها مع الحاجز، وبسببه تسترجع حياتها الماضية في ضوء الأزمة الراهنة.
ويبدو الحاجز فضاء سقط من كتاب “شعرية الفضاء” لغاستون باشلار، فلا هو بالطريق ولا هو بالمعتقل ولا هو بالجسر رغم تمدده في كل هذه الفضاءات وتعالقه بها. إنه فضاء المخاطرة بالحياة كالمشي في حقل الألغام. هكذا كانت شخصيات رواية باسمة تتعامل مع الحاجز كتجربة موت يومية وامتحان مصيري يتغير استقباله للشخصيات حسب الوضع الأمني ومزاج الحراس وأوامر الحكومة الإسرائيلية.
تدور أحداث الرواية في يوم واحد حول مكان إشكالي واحد هو حاجز قلنديا، مما يدفع بالرواية نحو شكل النوفيلا إذا استحضرنا أن صفحاتها لا تتجاوز المائة صفحة بكثير غير أن هذه النوفيلا تلخص ضراوة الحياة وقسوتها في القدس المحتلة.
الدفن عمل شاق
يعيش زياد مأزقا خاصا مع الحاجز، فخلافه مع والده لا يمكن أن يدفعه إلى ترك جثته في رام الله، فقد قضى الأب نحبه في زيارتها ويتوجب على زياد عبور الحاجز لتسلمها والعودة بها إلى القدس حيث يجب أن يدفن. إن هذا المأزق يذكرنا برواية السوري خالد خليفة “الموت عمل شاق” الذي كتبها بعد سنوات من كتابة باسمة لروايتها، وفي رواية خالد خليفة يجد البطل الابن الذي توفي والده تائها بجثته بين الأراضي السورية التي صارت مقسمة بين الفصائل المتقاتلة والتي كانت تحول دون أن ينفذ الابن وصية والده في أن يدفنه في مكان معين. مع باسمة التكروري نكون أمام واجب الابن على والده وقد اصطدم بواقع الحاجز وعبر هذا المأزق ينطلق الراوي العليم في التوغل في حياة الابن وابيه وتاريخ الأسرة.
“استيقظ زياد ذلك الصباح وهو متأكد تماما من أن ما فعله في الليلة السابقة كان السبب. خرج بملابسه المبهدلة وملامحه المتعبة كمن لبسه جني، حين وصلته الأخبار. ماذا يعني موت والده لم يقترب منه ولم يعرف كيف يرتبط به من قبل. بل إنه طالما خجل به، وعاش حياته ينزع عنه أي شبه به. إلا أنه الابن الأكبر، ولا يمكنه التهرب من المسؤولية، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل وإجراءات التسلم وترتيب التغسيل والدفن وخبر الجريدة، والاتصال بالمقبرة، والمقرئ واستئجار الكراسي وشراشف الميتم الحمراء والاتفاق مع المغسل، وإعلام إمام الجامع بوقت الميتم ليعلنه على السماعات وترتيب غداء الميتم، والقهوة، والتمر والكنافة الخشنة، ومهام تسلم أكياس السكر والبن والبيت الذي ستخزن فيه، كلها تفاصيل هجمت على رأسه كمطارق لا ترحم فجأة لحظة أغلق السماعة مع أمه”. ص 8
يكتشف زياد أن العبء عليه مضاعفا، فزيادة على واجب تحمل المسؤولية وتسلم جثة الأب من رام الله، بصفته الابن البكر فإنه يجب أن يقوم بكل ذلك في وقت قياسي، فالميت يجب أن يدفن عقب صلاة الظهر، وعليه فإن كل تفاصيل الجنازة، والتغسيل، والإعلان، يجب أن تتم في وقت ماراثوني” ص 11 مع الأخذ بالاعتبار أن الجثة في رام الله وقد يتأخر الدفن لليوم الموالي.
تحملنا باسمة التكروري شيئا فشيئا عبر أفكار الشخصية إلى فداحة الموقف فليس الأمر سهلا أبدا وليست مجرد مهمة وواجب عائلي، إذ كانت الجثة في منطقة الحكم الذاتي في رام الله وعليها أن تدفن في القدس.
فـ”سيكون على زياد، أن يرتب لسيارة نقل الموتى، كي تنتظره على جهة القدس من حاجز قلنديا العسكري، وعليه بالتالي أن يقطع الحاجز بالجثة ويقنع الجنود بأن والده من القدس، ومن بعدها سيتعين عليه تصديق شهادة الوفاة من المحكمة الشرعية، وبعدها ما هو أصعب، أن يبقى مع جثة والده ليلة كاملة”.
تنقل لنا الكاتبة فضاء الحاجز في كتابة مشهدية ترسخ عبرها بؤس الفضاء ووعورته من قبل الوصول إليه عندما نبه سائق الباص زياد أن عليه أن ينزل: “احنا على قلنديا، الباصات ممنوع تدخل، بدك تنزل تصف عالحاجز”. ص16
إن هذا المشهد يضيف للحاجز سمة أخرى، أنه فضاء مسيج ومحظور على العربات، ليكون البشر في مواجهة مصيرهم التراجيدي المعتاد عبر طابور القيامة كما شبهه الراوي. ليتحول زياد عبر رحلة المشي في الطابور الذي لا يتحرك تقريبا، إلى خرقة بالية وجائعة.
ولم تكن الكاتبة لتكتفي بهذه التراجيديا الإنسانية، بل زادت في التنكيل بشخصيتها عندما جعلته ينتبه لحظة وصوله إلى الحاجز أنه نسي بطاقة هويته لدى رفاقه الذي كان قضى معهم ليلته الماجنة. ولم يكن من حل إلا العودة إلى القدس لكي يجلب معه البطاقة غير أن الجنود الإسرائيليين تنبهوا إليه فجروه إلى خلف الكشك “وأشبعوه ركلا في معدته ورأسه وكل أنحاء جسده” ص17. وكان ذلك العنف مضاعفا لأن الجنود خيل إليهم أنه شخص من رام الله تسلل إلى القدس فكالوا له الضرب بأعقاب البنادق والأحذية العسكرية في الرأس ومناطق حساسة. ولم ينجح زياد في الكلام إلا بعد وقت ليتأكدوا أنه صادق فألقوا به من جديد في الجانب الآخر من الحاجز.
في تلك اللحظات من الخيبة والحيرة كانت الكاتبة أمام فرصة جديدة لتعمق من تاريخ الشخصية عبر الغوص في ماضيها وتشكلاتها النفسية والفكرية، وهي مناسبة لتفشل الكاتبة أفق انتظار القارئ عندما تعلمنا أن هذه الشخصية ليست من تلك الشخصيات الفلسطينية الأيقونية التي رشح بها الأدب الفلسطيني إنما هذه شخصية عادية من الشوارع الخلفية للقدس وباب العامود، حيث طموحه ليس أكثر من أن يصبح أحد الشطار في مجتمع من المهمشين وضاربي الحشيش ورجل صاحب سلطة وسيطرة في فضاء يرشح بالجريمة. ولكن في طموحه رغم ذلك شيء من الفروسية الوراثية جعلته يحلم بامتلاك حصان أكثر من امتلاك وظيفة حكومية، طموح يليق بتاريخ عائلته التي ينحدر منها عائلة “أبو مخلب”.
أزمة الأجيال المتعاقبة
تكشف الكاتبة أننا مع جيلين من الفلسطينيين يشتركان في ذلك السقوط ضحايا، لتستند على معاناة الجدة “الرسن” في محاولاتها تربية أبنائها “وعزلهم عن الواقع الذي يحيط بهم” دون فائدة فقد كانوا “ضحية جيل سبق جيل الانتفاضة الأولى، في محيط مدينة القدس والبلدة القديمة على وجه الخصوص، في خضم مخطط استيطاني شامل طالما استهدف المدينة. وأخطر ما كان يرمي إليه هو تخريب أبنائها، وتسكين عقولهم بجرهم إلى السكر وإدمان المخدرات. وهي إذ تتشدد في تربية أحفادها، وتنفذ الأحكام العقابية، والهدايا التعزيزية بيدها وحدها، إنما كانت تحاول إصلاح ما يمكنها إصلاحه في ظل كل ذلك”. ص 29.
في المستشفى يكتشف زياد استشهاد عمه الوطني فيكون أمام جثتين، جثة أب مستقيل غارق في المخدرات والشرب وعم مناضل، وكأن بالكاتبة تقول إن الموت يلاحق الجميع مثل الحاجز البشع.
هكذا تضيف الكاتبة مصادفة جديدة، فكل ما يحدث كان يحدث في ذلك اليوم المرعب الذي بدأ فيه اجتياح رام االله واكتشاف زيف معاهدة السلام، اتفاقية أوسلو، حيث اجتاحت المزنجرات رام الله يوم الثامن من مارس/آذار 2002 لإسقاط ياسر عرفات، مهندس اتفاقية السلام.
عبر تقنية التناوب بين الشخصيات تبني باسمة التكروري روايتها وتوزع أحداثها، فتحمل الفصول أسماء الشخصيات دون زيادة، وهذا يسهل عملية التلقي، لكن هذه التقنية التي عرفت منذ وليام فوكنر لصيقة بتعدد الأصوات حيث كل شخصية تروي بلسانها الأحداث، تقودها باسمة التكروري في هذه الرواية براو عليم يعلم كل شيء مثل إله سردي، يخترق العقول والذاكرة والمشاعر متجسسا على حركتها عبر الأزمنة المختلفة.
في إمكان قصة زياد وأبيه أن تشكل عالما روائيا كاملا لكن الكاتبة اختارت أن تثري هذا الفضاء بأصوات نسائية أخرى تعكس معاناة المرأة الفلسطينية في القدس وحياتها اليومية تحت الاحتلال، وهنا تظهر شذى ومنار وليكون الحاجز الفضاء الذي تلتقي فيه الشخصيات الثلاث، ليسترجعوا العلاقات التي جمعتهم في الطفولة والمدرسة وأسباب فراقهم. تسبب هذا الاختيار في تراخي السرد في القسم الثاني من الرواية قبل أن يستعيد نفسه مع المشهد الأخير مع الحاجز عندما تفتح البوابة ليستعيد كل شخص فردانيته ويركض وحيدا نحو البوابة. كان زياد عائدا بهوية عمه الذي استشهد في رمزية لاستمرار المقاومة واستمرار الصراع مع الحواجز.